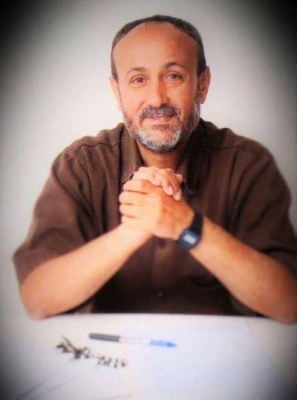«أنا الأديب الأدباتي» عبارة تأخذنا إلى زمن قديم من أزمنة مصر، وتذهب بنا إلى القرن التاسع عشر عندما كان الوطن يصارع العثمانيين والإنكليز في آن واحد، الاحتلال العثماني القديم الذي لبث قروناً من الزمان ينخر في بنيان البلاد، والاحتلال الإنكليزي الحديث بقوته وجبروته. كانت مصر تقاوم وتحاول محو آثار الجهل والتخلف والجدب، الذي سببه الاحتلال العثماني في جميع المجالات، ذلك الاحتلال الذي جاء في لحظة مظلمة حالكة من تاريخ الوطن عقب فساد وانحلال المماليك. كانت أسرة محمد علي تسعى للتخلص من العثمانيين تدريجياً عن طريق تقوية الجيش المصري، كما كانت تسعى نحو العلم والتقدم والنهوض بالبشر، وكان الحكام الذين تعاقبوا على مصر من الأسرة المحمدية العلوية يكملون النهضة التي قام بها جدهم محمد علي باشا، ويواصلون العمل على بناء الدولة المصرية ووضعها في مصاف الدول القوية، بالتركيز على التعليم والثقافة وتكوين النخب المستنيرة التي تقود المجتمع، وتأخذ بيد الشعب وتخرج به من الظلمة إلى النور.
«أنا الأديب الأدباتي» عبارة ترتبط برجل من رجال مصر، لم تنسه ذاكرتها ولم يبرح مخيلتها ولم يفارقها صوته المؤنس، أديب وشاعر وزجال وصحافي ومسرحي وخطيب مفوه نادر المثال، اختلطت كلماته بتراب الوطن، ورسخت في باطن أعماقه. عرفنا تلك الكلمات أم لم نعرفها، فإنها تسللت بشكل غامض إلى الضمير، أو هي قائمة في الوجدان بصورة خفية، وربما يبقى اسم صاحبها مألوفاً حتى لدى من يجهله، فعندما نسمع اسم عبد الله النديم نشعر برابطة ما تربطنا به، رابطة نُثرت بذورها منذ القدم وتوزعت على المصريين في أرجاء مصر. فنحن عندما نستمع إلى عبارة «أنا الأديب الأدباتي» لا نتذكر إلا عبد الله النديم، ذلك الاسم الخالد في تاريخ مصر، البعيد عنا زمنياً والقريب إلينا وجدانياً، ذلك الحلم غير المكتمل أو الصورة ناقصة الملامح.
نعرف الكثير عن حياته وسيرته، لكننا لا نعرفها كلها، نقرأ له الكثير مما حُفظ وخلد وبقي، لكن الأكثر ضاع واندثر ولم يصل إلينا، وربما كان لذلك النقص والخفاء وعدم الاكتمال دور في شدة التعلق، والتطلع إلى النديم دائماً برغبة قوية في الاستزادة والإشباع. فالنديم ليس مجرد أديب من أدباء مصر، وليس أديبها الكبير أو جاحظها فحسب، وإنما هو جزء من تاريخ مصر وتاريخ الشعب المصري على هذه الأرض، ومن خلال النديم وكتاباته تنفتح لنا نافذة نستطيع أن نطل منها على مصر قديماً، وأن نكتشف الكثير من الجوانب الاجتماعية والسياسية والفنية. وقد تقاطعت سيرته مع حدث تاريخي من أحداث مصر الكبرى، الذي هو الثورة العرابية، فكان النديم مقرباً من العرابيين، وكان خطيب تلك الثورة وحلقة الوصل بين رجالها العسكريين وعموم الشعب الذين لم تكن لهم علاقة مباشرة بمطالبها، لكنها كانت ستنعكس عليهم بكل تأكيد في نيل المزيد من الحقوق للمصريين مقابل الأتراك والإنكليز.
النديم وثورة عرابي
قامت الثورة العرابية في الفترة من عام 1879 حتى عام 1882 وقائدها أحمد عرابي باشا، الذي كان ضابطاً في الجيش المصري برتبة قائمقام، وهي رتبة صغيرة، لأن المصريين لم يكن يحق لهم الترقي إلى الرتب العسكرية العليا، التي كانت تقتصر على الأتراك والشركس، لذا قامت الثورة احتجاجاً على هذه التفرقة وحرمان الضباط المصريين من حقوقهم الطبيعية في وطنهم، بالإضافة إلى الاحتجاج على بعض الأوضاع السياسية الأخرى، وكانت مطالب الثورة، وفقاً لما كتبه أحمد عرابي نفسه، هي العدل والمساواة في الترقية، استبدال ناظر الجهادية، تشكيل مجلس نواب للأمة، تعديل قوانين العسكرية وزيادة عدد أفراد الجيش. فقام الخديوي توفيق بترقية أحمد عرابي إلى رتبة أميرالاي، وعزل عثمان رفقي ناظر الجهادية، وقال العرابيون للخديوي أن يختار اسماً آخر لنظارة الجهادية، لكن الخديوي رفض وطلب منهم هم أن يختاروا من يريدونه، فاختاروا محمود سامي باشا. ورغم تلبية معظم المطالب تشابكت الأمور وتعقدت وعمل الأتراك والإنكليز على إشعال الفتن، ووقعت مجموعة من الحوادث بدأت بحادثة الإسكندرية، وانتهت بحادثة التل الكبير التي شهدت الخيانة والغدر بعرابي ورفاقه، أو بما يطلق عليه أحمد عرابي «الخذلان العظيم»، وانتهت الثورة بنفي عرابي وبعض رجاله إلى جزيرة سيلان لنحو ما يقرب من عشر سنوات، ثم عاد أحمد عرابي إلى مصر وعن هذه العودة يقول شاكراً الخديوي عباس حلمي الثاني: «صدرت الإرادة الخديوية بالرخصة لي بالعودة إلى مصر والإقامة فيها، وإني أرجو من مكارم سمو مولاي الخديوي عباس باشا تمام رضاه، وقد أعرضت لسموه العالي تشكراتي ودعواتي الخيرية الصادرة عن صميم الفؤاد وإخلاص النية، وقد تفضل حفظه الله بحملي وعائلتي إلى مصر على مصاريف حكومته الخديوية». ويؤكد عرابي ما معناه أن ثورته لم تكن انقلاباً عسكرياً، أو تمرداً على الأسرة المحمدية العلوية، وأنه لم يشأ تأليف دولة جديدة، وإنه لم يكره تركياً ولا شركسياً، وإنما كان يريد العدل والمساواة وحفظ استقلال البلاد.
بينما كان عرابي يعيش كريماً مع عائلته في منفاه، كان النديم خطيب الثورة وأديبها وصوتها المسموع مطلوباً للمحاكمة، ورصدت مكافأة 1000 جنيه لمن يدل عليه، ولنا أن نتخيل قيمة هذا المبلغ في القرن التاسع عشر. كان النديم مشرداً داخل الوطن، مختبئاً متخفياً متنكراً طوال الوقت، ينتقل بين المدن والقرى ويرتحل براً ونهراً، بعيداً عن الأهل والخلان لا يصحبه سوى خادمه المخلص الأمين. عاش عبد الله النديم في الفترة من عام 1842 حتى عام 1896، وتعود أصوله إلى الشرقية، لكنه نشأ وتربى في الإسكندرية، حيث كان والده يعمل نجاراً في ترسانة صناعة السفن، ثم أقام فرناً خاصاً به يبيع فيه الخبز، تلقى النديم تعليمه القرآني في الكتاب، ثم تأهل للعمل في التلغراف، أحب الشعر والادب وأعجب حد الانبهار بالشعراء الذين كانوا يجلسون على المقاهي يمسكون بالربابة يعزفون ويروون السير والملاحم الشعبية الطويلة، التي تشغف الجمهور إعجاباً. قرأ الشعر وكتب الأدب القديمة وأظهر نبوغاً في الحفظ والقول والارتجال في تآليفه الخاصة، وكان مشهوراً بظرفه وحسن مجلسه، وما يرويه من فكاهات، كان أدباتياً يسير بين الناس ويجمعهم في مجالس من حوله، يحكي لهم القصص والنوادر والطرائف، ويلقي عليهم الشعر والزجل، ويرتجل الأحاديث الشيقة إلى ما لا نهاية، وهو في هذه الحالة لم يكن يمارس فن الكلمة فقط، وإنما كان يختلط لديه الأدب والشعر بفنون التمثيل والإلقاء الصوتي والأداء الجسدي، وكل ما يجذب الجمهور ويستقطب العامة ويؤثر في الناس، ويمكن القول إنه كان وسيلة إعلامية فنية صحافية متكاملة. ذاع صيته وكان محبوباً ومرغوباً من الجميع، وكان لا يزال في مطلع الشباب، ثم حدث أن التقى بجمال الدين الأفغاني، الذي سيجتمع به مرة أخرى في المنفى الأبدي عند نهاية العمر، فتأثر به أيما تأثر وأصابه ما يشبه اليقظة الذهنية والصحوة الوطنية، والانتباه الشديد إلى أحوال مصر وضرورة إصلاحها، فتغيرت علاقته بالكلمة وتضاعف شعوره بدوره المهم الذي يجب أن يقوم به.
ثم جاءت الثورة العرابية، وكان مقرباً من رجالها وعلى رأسهم أحمد عرابي ومحمود سامي البارودي شاعر السيف والقلم، فانغمس النديم في السياسة والحركة الوطنية الإصلاحية. ولد النديم في عهد محمد علي باشا، ثم أتى ابنه إبراهيم باشا الذي حكم لمدة شهور فقط، وجاء من بعده عباس باشا الأول، ثم تلاه الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل، والخديوي توفيق الذي اندلعت الثورة في عهده، وتلاه الخديوي عباس حلمي الثاني، عاصر النديم كل هؤلاء إلى أن توفي منفياً في الإستانة وهو لا يزال في بداية الخمسينيات من عمره. وعن الخديوي عباس باشا الأول الذي أرسل مجموعة من الطلاب إلى ألمانيا والنمسا لدراسة الطب ومختلف العلوم، كتب النديم يثني على الخطبة التي ألقاها الخديوي على هذه الإرسالية قبل سفرها، وذكر كلمات الخديوي التي تقول: «يا أولاد مصر أنا أرسلكم إلى بلاد ألمانيا والنمسا، ولا أرسلكم إلى فرنسا لئلا تفسد أخلاقكم بكثرة الملاهي فيها، فاجتهدوا في تعلم العلوم التي تسافرون لطلبها، ووالله العظيم إذا رجع أحدكم غير متعلم ومحصل كما ينبغي، لابد أن أرده للفلاحة ليمسك النطّالة ويقعد طول النهار يقول يا حدويه وحدويه». ويقول النديم إن هذه الخطبة كانت سبباً في اجتهاد الطلاب ونجاح الإرسالية على أكمل وجه.
بعد سنوات الهروب الطويلة وعندما أمسكت به الحكومة لم يعاقب النديم بالإعدام أو السجن، وإنما عوقب بالنفي وخُيّر في البلد الذي يود الذهاب إليه فاختار فلسطين واستقر في يافا، وصرف له راتباً منتظماً وعن هذا يقول: «جاء الأمر الكريم بسفري إلى الأقطار الشامية المحروسة، ممتعاً بحياتي ممنوحاً مادة معاشي مرسلاً على صورة التكريم والإجلال، موعوداً بدوام العناية بي مبشراً بقرب العفو عني، فامتلأت قلوب الأحباب سروراً، وانطلقت ألسنتهم بالثناء على الحضرة الخديوية التوفيقية». وبعد موت الخديوي توفيق كتب قصيدته الدالية تأبيناً ورثاء له. وكتب كذلك يمدح الخديوي عباس حلمي الثاني الذي خلف الخديوي توفيق، والذي أصدر عفواً عن النديم وأمر بعودته من يافا إلى مصر، لكن الإنكليز نفوه بعد ذلك وتحديداً اللورد كرومر، الذي أمر بإبعاده إلى الإستانة، وهناك عينه السلطان العثماني مفتشاً للمطبوعات في الباب العالي. وكانت آخر كلمات النديم المطبوعة لقرائه في مصر، وداعاً لم يفصح عن أسبابه، التي كان يعلمها ويستعد لها حيث قال: «أودعكم والله يعلم أنني أحب لقاكم والخلود إليكم، وما عن قلى كان الرحيل وإنما دواع تبدت فالسلام عليكم».
الصحافي والناشر الحصيف
كان النديم صحافياً ألمعياً في زمانه، وناشراً ومطبعياً حصيفاً، أصدر جريدة «التنكيت والتبكيت» التي اختصت بالنقد السياسي والاجتماعي بأسلوب بسيط قريب إلى العامة، وأصدر كذلك جريدتي «اللطائف» و»الأستاذ» فيما نعلم. لم تكن تلك الإصدارات على الشكل الذي نجده في بدايات القرن العشرين بطبيعة الحال، وقد يبدو أسلوبها غريباً إلى حد ما، وكذلك أسلوب النديم في الكتابة، لكن ما أن يضع المرء نفسه في إطار عصرها القديم، سوف يسهل عليه قراءتها وتلمس أفكارها ومواطن الجمال فيها، وسوف يعجب بذلك المستوى من الفكر والأهداف النبيلة التي كانت تنشرها وترومها تلك الصحف. لا نجد فيما قرأناه من كتابات النديم أفكاراً متخلفة أو متشددة، بل نجد أنه كان يدفع المجتمع إلى الأمام، ويحثه على التخلص من الأفكار الخاطئة غير السليمة، التي تضر وتؤخر، ونلاحظ أنه لم يكن يفعل ذلك بفوقية واستعلاء على الشعب، أو عن طريق الصدام معه، وإنما كان يسعى نحو ما يرجو ويبتغي بأسلوب لطيف هادئ مقنع، ولم يكن يصطدم بالعادات والتقاليد بعنف، لكنه كان يحاول أن يحقق التغيير برفق من خلال كسر الجمود، وفتح ثغرة تمرر الضوء وتنشر النور. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك، وتدل في الوقت ذاته على براعته كصحافي وبعد نظره كناشر، عندما قرر أن ينشئ جريدة «المربي» الجريدة النسائية البحتة التي تتناول كل ما يهم ويفيد المرأة في ذلك الزمن، ويثقفها في جوانب التربية والرعاية الصحية وتدبير شؤون البيت والأسرة مالياً ومعنوياً. أراد النديم للنساء أن يمارسن الصحافة والكتابة وكان ذلك في القرن التاسع عشر، عندما كان اليشمك العثماني لا يزال يغطي وجوه كثير من النساء في مصر، فكتب يشجع النساء على مراسلته قائلاً: «وإني كذلك أرجوهن أن يبعثن لي أفكارهن في المواضيع التي تطرأ عليهن، وما يقع لبعضهن من نادرة أدبية أو واقعة مفيدة، مما يصدر وهن خلف الحجاب، ولهن أن لا نصرح باسم واحدة منهن إلا من شاءت ذلك، فمن أرادت الاشتراك فلتخاطبنا بواسطة بعلها أو ابنها أو محرم لها».
كما كان في ذلك الزمن القديم يقدم كتاباً على هيئة أجزاء هدية للمشتركين في الصحيفة مع كل عدد من أعدادها، ومن هذه الكتب كتاب عن المتحف المصري للأثري أحمد بك كمال، وكان النديم يؤرقه قلة علم المصريين بتاريخ الفراعنة، بينما يحيط به الفرنسيون كل الإحاطة، لذا كان متحمساً لذلك الكتاب الذي قال عنه: «فجاء كتاباً نفيساً لم يؤلف باللغة العربية مثله، ولا جمعت الكتب الإفرنجية ما جمعه بالبيان والتفصيل».
وعن فن التمثيل الذي كان محتقراً في ذلك الزمن كتب النديم يقول: «فن بديع يقوم في التهذيب وتوسيع أفكار الأمم، وإخبارهم عن الوقائع التاريخية والتخيلات الأدبية مقام أستاذ وقف أمام تلامذته يلقنهم العلم». وكان يتحدث عن الفرق المسرحية والعروض التي يرى أنه يجب مشاهدتها والاستفادة منها، فيذكر مثلاً فرقة الشيخ سلامة حجازي ومن معه من الممثلين، أحمد أبو العدل وحسين الإنبابي، وثلاث ممثلات لم يذكر أسماءهن، وتحدث عن إشادة الأمراء وكبار الشخصيات بهذه الفرقة، واستشهد برأي علي باشا مبارك الذي قال: «إنهم أولى بالتشخيص في الأوبرا لإحسانهم التمثيل، وعدم وجود فرق بينهم وبين الأوروبيين». وكان النديم يعلن عن الفرقة ويدل على أماكن عروضها، التي كانت تقدمها كل جمعة وأحد وأربعاء في مسرحها في شارع عبد العزيز، وكل اثنين في حلوان، ويقول النديم: «فنحث أبناء مصر على الإقبال عليهم سعياً خلف ما فيه منفعة النفوس وتكثير الآداب». كما كان يعلن عن عروض لفرق أخرى، كعرض مقامات الحريري على المسرح بصيغة مقبولة لدى الجمهور، ورواية الملكة بلقيس في تياترو الباراديزو.
الكاتب يتحول إلى حكاية
لغة النديم قديمة لكنها بديعة ساحرة، وأسلوبه جاذب بشدة، فيه التدفق والاسترسال مع تحديد المعنى والهدف، فلا يضيع القارئ بين المفردات والكلمات المتراصة، ويسأل ماذا يريد هذا الكاتب أن يقول، وما هو موضوع ما أقرأ. واللافت لدى النديم أنه ككاتب تحول إلى بطل شعبي وأسطورة تروى، فيها المغامرة والخيال والتشويق الذي يثير الفضول، فالأديب الذي كان يروي الحكايات تحول هو نفسه إلى حكاية مثيرة تطغى على أي حكاية أخرى. كان النديم شاغل الناس طوال عشر سنوات من الاختفاء والاختباء، حيث ذاب بين الناس ولم يتمكن أحد من العثور عليه طوال هذه المدة، وكان النديم يمثل على أرض الواقع لا على خشبة المسرح، فكان أثناء هروبه يرتدي زياً مغربياً ويتحدث اللهجة المغربية، التي سمعها من المغاربة في الإسكندرية، وقد يستمر في أداء هذا الدور لشهور متتالية، ثم يذهب إلى قرية أخرى فيتنكر في شخصية يمني أو نجدي، ويمثل أنه شيخ ضرير يقوده خادمه، كما أن رحلة النديم التي لم يرافقه فيها سوى خادمه المطيع، هي في حد ذاتها فكرة أدبية تجسدت في العديد من الروايات والمسرحيات، لكنها عند النديم كانت حقيقة واقعة.
إلى جانب ما فقد وضاع من كتب النديم ومؤلفاته، يجب الأخذ في الاعتبار أن الجزء الشفاهي من أدبه، وهو كبير لم يحفظ، كما أن خطبه العظيمة لم تسجل ولم نستمع إليها، لكننا بما هو متوفر من كتاباته نستطيع أن نلمس شيئاً من أسلوبه في مخاطبة الجماهير، كقوله هذا على سبيل المثال: «فالله الله أيها المصريون في أنفسكم وأميركم وأعراضكم وأموالكم وبلادكم، جاهدوا أنفسكم في توحيد كلمتكم، وارجعوا بمحافلكم عن أبواب أوروبا وفتنتها، واخدموا بلادكم بظهوركم أمة واحدة واقفة على قدم الخدمة لأميرها، والمحافظة على حقوقها والمطالبة بخصائصها، ولا تشغلكم المظاهر الأجنبية عن تصحيح أغاليطكم وتطهير بواطنكم، ولا تظنوا أنكم عاجزن عن استرجاع مجدكم والقيام بأعمالكم، فإنما أنتم بشر مثل رجال أوروبا، ولكنهم تجمعوا وافترقنا، وعرفوا حقوقهم وجهلناها».
مع النديم نكون أمام صورة مختلفة للأدب والأديب، صورة تتلاشى فيها الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال، وتختفي الحواجز بين المبدع والجمهور، وعلى الرغم من أنه كاتب عظيم تتطلع إليه ولا شك كل الأقلام المصرية التي جاءت من بعده، فلا نظن أن هناك من الكتاب من اختلط بالعامة وتقلب في دروب مصر وشوارعها كالنديم. فالنديم كان يحمل كلماته ويمشي بها بين الناس فعلاً لا تخيلاً، ويقول «أنا الأديب الأدباتي معروف بوقفتي وثباتي» ليوصل فنه إلى الناس ويسمعهم قوله، ويشيع في نفوسهم جمال أدبه وبديع شعره. كان النديم نديماً بحق، ينادم أهل مصر ويؤنسهم ويخلصهم القول، ويبصرهم بما يجب أن يكونوا عليه وبما يجب أن تكون عليه مصر.
*كاتبة مصرية